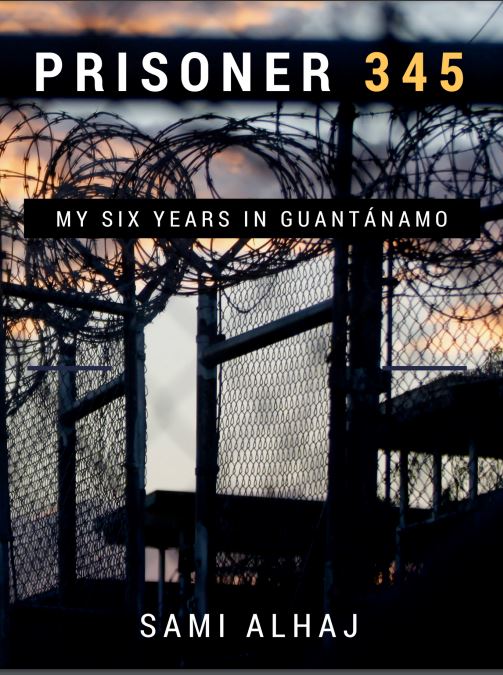في زمن كورونا، هل إلى هدأة التسليم من سبيل؟
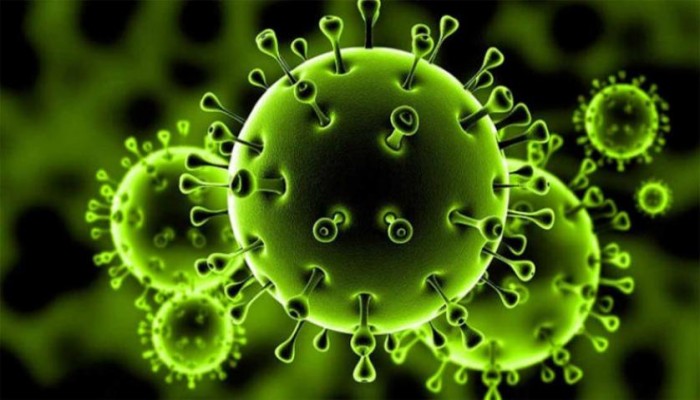

مقال يكتبه الدكتور/ كريم الماجري
باحث أول بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان
من المُفزع أن يتخيّل الإنسان-الذي خُلق حرا- أن تكون أشد خصوصياته حساسية، في يوم ما، مستباحة. ومن المُخيف أن يتحكم في مصيره وخياراته، بل وحتى رغباته وتحركاته وكلّ أفعاله، عالم من اللاّمرئيات المُتخفية داخل كل شيء. من غير المُحتمل أن يكون العدوّ متلبّسا بكل شيء وعلى هيئة أيّ شيء، إنسانا آخر كان أو أياّ من الوسائل والأدوات التي نستخدمها لنستعين بها على إنجاز أعمالنا اليومية. لقد أصبح العدوّ يصاحبنا كظلالنا، خارج أماكن سكننا، بل وفي داخل منازلنا أيضا، فأنت إذا ما تجاوزت عتبة باب بيتك فإنّك تلج إلى عالم من الأعداء المتربّصين بك في كل زاوية ويقعدون لك كلّ مقعد، أما في داخل بيتك فأنت مراقب على مدار الساعة من قبل آلاف الأقمار الصناعية التي ترقب حتى أنفاسك، وتعدّ عليك كل حركاتك، حتى إنه يمكنها استباق تفكيرك فتدلّك على ما تبحث عنه بكبسة زرّ. الهواتف الجوالة تراقبنا، وأجهزة التلفزيونيات من الجيل الجديد تفعل ذلك، وكاميرات المراقبة المثبّتة عند كل زاوية من العمارة التي تسكنها تُكمل مهمة الإحاطة بك وبتحركاتك، فكل تلك الأجهزة ترصدك وتنقل معلوماتك إلى جهات سرية، وأخرى معلومة، تجبرك على الانصياع لنظامها والقبول به وإلا فإنّها تحجب عنك ما تكتنزه من معلومات تحسبها ضرورية، فتقبل بالرضوخ لها طواعية وأنت مكره.
اليوم، متخفّية وراء فيروس كورونا المستجدّ، تعمل الحكومات والشركات النافذة في مجالات عدّة، وفي مقدمتها شركات التأمين والأدوية والشركات المسيطرة على فضاء المعلوماتية، والجهات الاستخباراتية والعسكرية، ومراكز تحليل المعلومات ووسائل الإعلام المسيطرة على هذه الصناعة والمنظمات السرية والعلنية…وغيرها كثير لا يحصى، على تخويفنا من ذلك العدو اللاّمرئي، هدفها ترويض الأفراد وفقا لنفس السلوك القائم على الفعل وردّ الفعل وتحملنا قسرا على التخلي عن أسرارنا الشخصية و حياتنا الخاصة بحيث نكون جميعنا خاضعين لرقابة صارمة بفعل مزيد من تدخل كل أنواع التكنولوجيات في حياتنا. كل تلك الكائنات تسعى إلى أن تعرف عنا أكثر، أن تحوّلنا إلى خطر محتمل يجب السيطرة عليه وتحويله إلى سلعة قابلة للبيع والشراء والتداول…حتى أوقات فراغنا تحولت إلى سلعة. أما ثقافة المجتمعات والمجموعات العرقية والدينية والثقافية المتمايزة فقد بدأت تنهار بفعل التقدّم التكنلوجي، لقد أصبح أغلبنا يعيش في عوالم افتراضية لا أسس لها قيمية، ولا تعترف بأخلاق ولا بدين غير الرّبح وتحقيق رفاهية هلامية يُسحق فيها من لا يستحقونها من الفقراء والمهمشين.
في عالم اليوم الذي تطغى عليه رفاهية كاذبة هلامية، ازدادت حياتنا تعقيدا وأصبح واقعنا أكثر ظلما وجورا وباتت أخبار القتل والجريمة من المفردات التي نسمعها يوميا دون أن تدفعنا إلى التأمّل فيها وفي أسبابها، ودون أن تذكّرنا بإنسانيتنا، هذا في وقت تبشّرنا فيه التكنولوجيات الحديثة، والمتحكمون فيها، بتبسيط حياتنا وتيسيرها. وفاضت مصادر الأخبار، الموجَّهة والمغرضة منها، وتلك التي نُنتجها نحن المستهلكين ونبثها عبر وسائط التوصل الاجتماعي، بمعلومات جلّها مغلوط ومخادع، بل ومفبرك في عديد من الحالات. نعيش اليوم في عالم تطغى عليه أخبار فيروس كورونا، حيث بات تعميم الكذب وترويج السردية المراد إيصالها إلى الجميع بشتى السبل هدفا في حد ذاته، تغيب معه الحقيقة والمعلومة الموثوق فيها، التي تضيع بين آلاف المعلومات الكاذبة أو المخادعة أو المنقوصة، ونسمع فيه عبارات لم ولن نألفها تدعونا إلى “تباعد اجتماعي” هو أشبه بحبس أنفسنا في زنازين انفرادية ينعدم فيها التواصل الحقيقي بين البشر…
قال أبو حيان التوحيدي قديما: “إذا ناجاك الحق بما يدقّ عن الفهم فلا تحاكمه إلى نقص العقل… إذا فتنك العقل بدقائق البحث فاستقبله بحقائق التسليم” إنه تصوّف مرغِم في محراب الفيروس التاجي اللامرئي-تقف خلفه جهات معلومة-، هو تصوّف معاصر مليء بمغالطات الأرقام المقدّمة حول الوباء، كلما ظهر خبر مبشّر إلا وتبعه سيل من الأخبار المحذّرة التي تزيد المتابعين حيرة، فهل إلى هدأة التسليم من سبيل؟
كيف السبيل إلى ذلك، ونحن نعلم أن أكثر من 3.5 مليار شخص يعيشون بأقلّ من دولارين اثنين في اليوم؟ وتطالعنا إحصائيات عن أعداد مهولة من اللاجئين والنازحين الداخليين، وملايين يعانون من أمراض، ظنّ الجميع أنها باتت من الماضي، ويلقون حتوفهم بسبب فيروسات خبيثة تهدم حياة الآلاف حول العالم في كل يوم. كيف نهدأ ونحن نرى أنّ النموّ الاقتصادي المزعوم ما فتئ يعمّق الفوارق الاجتماعية بشكل مطرد، وأنّ التقديرات تقول إن عدد من سيكونون تحت خط الفقر سيبلغ في غضون سنوات قليلة 6 مليارات من البشر. لا أحد يذكّرنا بهذه الحقيقة في عصر كورونا-هُبل اللحظة الراهنة-. لا أحد يُخبرنا عن حروب قادمة لا محالة، إذا لم نستعدّ مبكّرا لمواجهتها أكثر من استعدادنا لمواجهة كورونا، فإنّها ستكون أكثر فتكا بالعباد. من بين تلك الحروب التي يلوح شبحها في الأفق حرب المياه، على سبيل المثال، حيث يعاني 1.5 مليار من البشر من نقص المياه الصالحة للشرب والريّ، وفي العام 2025 سيصبح 4 مليار شخص يعانون من نقص المياه أو شحها، وهو ما يعدل حوالي نصف سكان الأرض. 98% من مياه العالم مالحة، و2% فقط منها عذبة وهي موجودة إما في أعالي الجبال أو في شكل ثلوج…تكلفة تسييلها عالية لا تقدر عليها أغلب البلدان التي تعاني من فقر في الماء. والمياه الصالحة للشرب والرّي موزّعة على العالم بشكل غير متناسب، ففي أمريكا الجنوبية يوجد ربع الاحتياطي المائي في العالم، بينما يسكن تلك المنطقة 6% فقط من سكان العالم، في حين يعيش في قارة آسيا ثلثا سكان العالم وليس لهم سوى ثلث المياه الاحتياطية الصالحة للشرب والري…وهذا ينذر باندلاع صراع مرير وفظيع حول المياه سيفوق أعداد ضحاياه المحتملين بكثير بضع ملايين من المصابين بفيروس كورونا.
الغذاء أيضا يشكّل قضية أخرى كبرى، فحوالي 30 ألف شخص يموتون يوميا بسبب نقص الغذاء وغياب المخزون من المواد الغذائية وانعدام العدالة الاجتماعية، وهذه أرقام تتخطى بكثير أعداد من يموتون بسبب كورونا إذا ما صدّقنا الحكومات. أما المجاعة فتضرب أكثر من مليار شخص حول العالم، في حين أنّ الأراضي القابلة للزراعة لا تتجاوز مساحتها 1.5 مليار هكتار فقط… وأعداد من يموتون، أو سيموتون جوعا يفوق بكثير أعداد من يُحتمل إصابتهم بفيروس كورونا.
هذا غيض من فيض ما ينتظر المجتمعات البشرية في المنظور القريب، وهي كلها عوامل تقود إلى انعدام العدالة وتُفاقم الشعور بالاحتقان والمرارة والغُبن، وتشكل مصادر محتملة جدّا لصراعات الشاملة قد تشتعل في أيّ وقت…ولن تبقي ولن تذر، فكل ما سبق قد يقود إلى حرب شاملة تستخدم فيها أسلحة متطورة وأخرى جرثومية وثالثة نووية…فهل إلى هدأة التسليم من سبيل؟
في خضم كل هذه المخاطر المحدقة بالبشرية، يجد الإنسان العادي نفسه أمام تاريخين، أو روايتين مختلفتين للتاريخ؛ الأولى رسمية وهي كاذبة ومخادعة ومزوّرة، والثانية سرية وهي مخجلة ومهينة مليئة بالأخطاء والمقاربات غير الدقيقة، قوامها كذب متعمّد، ومغالطات تُقدّم على أنها حقائق، وهي في جوهرها تزوير وتشويه للحقيقة هدفها الترويج لفكرة أو نظرة أو قراءة أحادية لجعلها مهيمنة وحاكمة للمجتمعات…
وبالعودة إلى سيرة فيروس كورونا، ثمّة اليوم توجّس من العودة إلى الحياة الطبيعية بعد إعلان عدد من الحكومات بدء رفع قيود الحجر العام المفروض، بدرجات، منذ حوالي شهرين. ثمّة شعور مزدوج يعيشه الجميع حول ملاقاة الزملاء والأصدقاء وأفراد العائلة في واقع ما بعد رفع الحجر…هل نصافحهم ونعانقهم ونستمتع بالحديث إليهم، أم أننا سنخشى الإصابة بالفيروس؟ هل المطلوب تعقيم دائم ودوري لكل بقعة على الأرض؟ هذا محال. أما ما يزيد الناس إحباطا فهو أنه كلما ظهرت أنباء سارة تمنح بعض الأمل في مواجهة الفيروس إلاّ وتلتها موجة من الترهيب والتخويف والتحذير تعصف بكل أمل في القضاء على الفيروس، وتُعيدنا إلى المربّع الأول المخيف والمفزع، بينما يتواصل سباق محموم بين شركات تصنيع الأدوية واللقاحات التي تتبارى من أجل تقديم منتجها على أنه هو الأفضل، وهنا تُشترى ذمم سياسيين وإعلاميين كثر، بل وحتى أطباء وصيادلة وعلماء الأوبئة…فهل إلى هدأة التسليم من سبيل؟
- الأكـثر مشاهـدة
- الـشائـع